كتب: مروان ياسين الدليمي
الحدث الرئيس لرواية «وردة الأنموروك «أو بعنوانها الفرعي «سنة الأرمن» يدور حول النكبة التي واجهها الأرمن عام 1915 أثناء تهجيرهم من بلداتهم الأصلية التي تقع ضمن حدود الأراضي التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، وما شهدته تلك الأيام من انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. والمتن الحكائي للرواية يتمحور حول مصير عائلة لوسين الشخصية الرئيسة/الساردة للأحداث، التي اختفى المؤلف وراء قناعها فأوكل إليها مسؤولية السرد بدلا عنه.
مالذي يمكن أن يقدمه عمل روائي ازاء وقائع تاريخية لم تعد مصداقيتها قابلة للطعن، خاصة وأن هناك عديد الوثائق التي تؤكد حدوثها ممثلة بصور ومواد فيلمية ورسائل وشهادات لأُناسٍ عاشوا تفاصيلها؟ هذا السؤال لابد مِن انّ المؤلف قد طرحه على نفسه قبل أن يبدأ مشروعه الروائي. هنا تبدو صعوبة المهمة أمامه، فالتجربة الإبداعية تفرض على من يتولى إنتاجها ان ينأى بقصديّاتها بعيدا عن الدور التقليدي الذي عادة ما يمارسه المؤرخ عندما يتولى سرد وقائع التاريخ، في مقابل ذلك يحاول أن يلامس جوهر العمل الفني من غير ان يتلبسه التاريخ، وذلك بالعمل على تحفيز مخيلته لأجل ان تنهض بمهمتها الجوهرية في ابتكار عوالم وشخصيات من وحي الواقع لكنها لن تقف عند حدوده بل تتجاوزه وتفترق عنه. بنفس الوقت فإن حرية الخَلق التي يتحرك الروائي في مساحتها لن تكون وسيلته في تزوير الوقائع التاريخية بقدر ما تدفعه إلى أن يستثمر خياله للوصول إلى لحظة الصدق الفني، بالشكل الذي يضع المتلقي في موضع المتأمل للتاريخ من زاوية الفن، وليس من زاوية الواقع، ولن يتمكن المؤرخ من الوصول إلى ما يتوصل إليه العمل الفني بكل المقاييس، لأنه لا يمتلك مخيلة المبدع التي تمنحه القدرة على تعرية التاريخ، وهذا ما نجده قد تجسّد في السطور الأولى من هذه الرواية. ففي اللحظة التي تُبصرُ فيها لوسين جمجمةً من دون بقية عظام معروضة في مدافن مزجَّجةٍ اقيمت لضحايا الأرمن حتى تصدر عنها تنهيدة عميقة، حينها ينتابها شعور كما لو أن ضوءا ً ساطعا أغشى عينيها، وبعد أن تستعيد توازنها تُفاجىءُ ولدَها صوغومون بسؤال خاطف لم يكن يخطر على باله: «ألا يُحتمل أن تكون جمجمة جدّك وارتان أو خالك أرام؟».
وضعنا عواد علي أمام مشاهد تستثير ذائقتنا بما اكتنزته من جماليات واقعية، وهذا يعود إلى انه يمتلك لغة سردية مكَّنته من ان يتوغل في أعماق شخصياته وهي تواجه قدرها، ومثل هذا التدوين السردي بشكله الروائي بامكانه ان يكشف لنا حقائق وعلاقات جديدة دائما ما تسقط من سرديات كتب التاريخ .فالرواية هنا، تعيدنا إلى فترة كانت حبلى بأحداث كارثية على الشعب الأرمني، وهي فترة زمنية ليست بعيدة جدا عن ذاكرة الحاضر، خاصة وان هناك العديد من شهودها ما زالوا أحياء، هذا إضافة إلى توفّر مادة أرشيفية تكشف الكثير من وقائعها، إلاّ ان المؤلف استغنى عن هذه الوثائق وأنتج لنا مادة سردية متخيلة، أوجدَ بينها وبين التاريخ علاقة استلهام. والسؤال الذي قد يُطرح هنا: إلى أي مدى يمكن للصياغة الفنية لأحداث مستلهمة من التاريخ أن تكون منفصلة أو ملتحمة بالواقع التاريخي إذا كان التخييل السّردي متورطا في ابتكارها؟ لاشك بأن السرد الروائي حتى وان استند على مادة تاريخية كما في رواية «وردة الأنموروك» فانه غير ملزم في أن يتموضع في حدودها بقدر ما يتحرك الكاتب في فضائه السردي وليس في حدود الواقع التاريخي. وعواد علي تعامل مع التاريخ باعتباره مادة خام لا أكثر، فأطلق العنان لخياله في ان يبتكر أحداثا وشخصيات تنبض بالمشاعر: «خَمَد نقيق الضفادع صبيحة اليوم التالي، وحلت محله زقزقات النوارس واصطفاق أجنحتها على سطح الغدير، مُحدِثةً ضجَّة لم نعهدها من قبل، ومِن بعيد كان يصل إلى أسماعنا نعيب غربان جائعة، كأنها استنفدت ما خبأت من طعام في أوراق الشجر».
يشير جورج لوكاش في كتابه «الرواية التاريخية» إلى أولوية المهمة التي ينبغي أن يضعها الروائي في اعتباره وذلك بان يكون حريصا على ان «تنتمي شخصياته إلى زمن محدد من حيث بنيتها الكلية، بذلك يتجنب الوقوع في فخ التجريد أو العدمية».
بهذا السياق يشير جورج لوكاش في كتابه «الرواية التاريخية» إلى أولوية المهمة التي ينبغي أن يضعها الروائي في اعتباره وذلك بان يكون حريصا على ان «تنتمي شخصياته إلى زمن محدد من حيث بنيتها الكلية، بذلك يتجنب الوقوع في فخ التجريد أو العدمية». هذا يعني أن يمضي قدما في بناء عالم متخيّل رغم أن روافده من الواقع، من هنا نجد بأن عواد علي قد أمسك بتفاصيل الزمن التاريخي عندما منح شخصياته ما تشير إليه من دلالات واقعية مشروطة بظرف موضوعي في إطار تاريخي محدد، فأضفى عليها حضورا إنسانيا وبملامح هوياتية معبأة بمعطيات اجتماعية: «قيل لنا، في الفندق الذي أقمنا فيه، إن تَل مرَقَدة الواقع بين دير الزور والحسكة يضم رفات مئات من الضحايا الأرمن، يكفي أن ينبش أحدهم التراب بيديه حتى تظهر الجماجم والعظام المدفونة. عندما بَلغنَاهُ لم أمتلك الجرأة الكافية على ازاحة التراب بيديّ خوفا من أهشم جمجمة أو عظما فجثوت على الأرض وصرت اتطلع بعينين متوجستين إلى الحجاج الذين أخذوا يزيحون التراب بأصابعهم في أناة، وخلال بضع دقائق ظهرت بالفعل عشرات الجماجم والعظام كما يظهر الكمأ تحت الأرض في الربيع».
أمام أزمنة مختلفة تمتد من نهاية القرن التاسع عشر وحتى مطلع الألفية الثالثة، أخذتنا هذه الرواية في رحلة طويلة لكنها جاءت على درجة عالية من التكثيف والاختزال، كشفت عن تفاصيل إنسانية عادة ما تحجبها سرديات المؤرخين الذين لا يتوقفون عندها ولا يتمكنون من الوصول إليها، بينما يكون اهتمامهم منصبا على سرد الوقائع والأحداث والتواريخ والأرقام. وفي هذه التفصيلة تتجلى أهمية التخييل السردي، فبقدر ما تبدو صلته واهية مع الواقع بقدر ما يؤكد خصوصية العلاقة معه بما يتوفر عليه من تقنيات سردية تمكنه من أن يتوغل بعيدا في أعماق الشخصية باعتبارها أهم عنصر في البنية الروائية، وفي هذا العمل على وجه التحديد تمثَّلَ المؤلف مشاعر شخصياته عبر شبكة علاقات متداخلة ضخّها في مكونات نصه السردي: «حين حل الظلام بدا لي العالم منقلبا من الذعر، قفاه فوق ورأسه تحت، النجوم منبسطة على الأرض، مضيئة كالسروج، والأجرام تدور كالمغازل حول نفسها، والسهول والهضاب والغدير معلقة في السماء. فركت عيني ّ وتطلعت ثانية فإذا بالظلام المحيط بي يتعاظم ويتحرك فوق الظلام البعيد، ويتوحدان، ويتحولان إلى شيء واحد، ويمسيان أشدّ اعتاما، ولا سبيل إلى التمييز بينهما».
تقنية المذكرات
جاءت تقنية السرد في هذه الرواية معتمدة على المذكرات التي دونتها لوسين في ثلاثينيات القرن الماضي بعد ان حطت بها الأقدار في مدينة الموصل وأصبحت تحت رعاية واهتمام امرأة عربية «جورية الشمَّرية» التي حافظت عليها كما لو انها ابنتها، قبل ان تتزوج وتنتقل مع زوجها ارمين إلى بغداد، والمذكرات باعتبارها وحدة فنية تملك خاصيتها الفريدة في البوح الذاتي ازاء تجارب مرت بها الشخصية المدونة، وفرت تقانة سردية اختفى المؤلف وراءها ليؤسس مخطوطته الروائية. هذه الثنائية في السرد حققت تماسكا فنيا في المتن الحكائي ومنحته بعدا واقعيا، فكانت المذكرات أقرب إلى ان تكون شهادة على ما جرى بصوت إحدى ضحايا النكبة إلا انها لن تتخطى قيمتها الفنية باعتبارها نصا سرديا في عمل روائي. والمنطوق السردي للرواية تضمن سلسة أحداث مرت بها لوسين خلال عمرها الطويل الذي تجاوز العقد التاسع، منذ أن كانت تعيش مع عائلتها في بلدة سيفان، هذا إضافة إلى أحداث سبقت ولادتها، وأحداث أخرى تسردها شخصيات أرمنية عرفتها لوسين عن قرب في بلدتها وعانت هي الأخرى نكبة التهجير والسبي والاغتصاب، أثناء رحلتهم الطويلة والشاقة من الأراضي التركية باتجاه عدد من المدن التي التجأوا إليها مثل الموصل وحلب ودمشق ودير الزور وبيروت والقدس وكركوك وبغداد: «كنا ثلاثة على ظهر حمار أشهب في قافلة المنفيين من سيفان، أنا لوسين ابنة الخامسة عشرة في المؤخرة، وأخي آرام الذي يكبرني بعام واحد في المقدمة، واختي الصغرى زاروهي ذات الاثني عشر عاما في الوسط. أما ابي وارتان وأمي تامار فقد كانا يسيران أمامنا، يملأهما الغم والكمد ويأخذ بأنفاسهما كأننا مساقون إلى المسلخ».
وفي تعامله مع الزمن اعتمد المؤلف على كسر تسلسله الموضوعي والأخذ بمسار الزمن الذاتي، بالشكل الذي منحه حرية مطلقة في نسج المتن الحكائي وفق حركة قائمة على الاسترجاع والاستباق، حسب ما تقتضي بنية السرد ودلالاته. والبداية كانت في شتاء عام 1991عند افتتاح كنيسة شهداء الأرمن في مدينة دير الزور السورية: «وفد المئات من مختلف الأعمار دفقة إثر دفقة إلى الكنيسة حاملين الشموع والورود لأحياء سنة الأرمن، ذكرى الإبادة الكبرى».
أخيرا لابد من الاشارة إلى ان عنوان الرواية الرئيس «وردة الأنموروك» يشير إلى وردة تحمل هذا الاسم، أهداها الفتى الأرمني آرشاك إلى حبيبته لوسين قبل النكبة بأيام معدودة، لأنها تعشق الورود، ولأنَّ لونها البنفسجي يرمز إلى العشّاق. أما العنوان الفرعي «سنة الأرمن» فإنه احالة إلى التسمية المخزونة في الذاكرة الجمعية حول ما جرى للأرمن في مطلع القرن العشرين.
عواد علي: «وردة الأنموروك»(سنة الأرمن)
دار الأهلية للنشر، عمَّان 2019
175 صفحة.
٭ كاتب عراقي
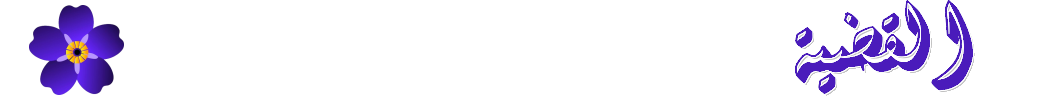 القضية قضية الشعب الأرمني
القضية قضية الشعب الأرمني





يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.